موسوعة الأخلاق الإسلامية-الحكم الأخلاقي وأسسه وغاياته (شروط ترتب المسؤولية 4 )
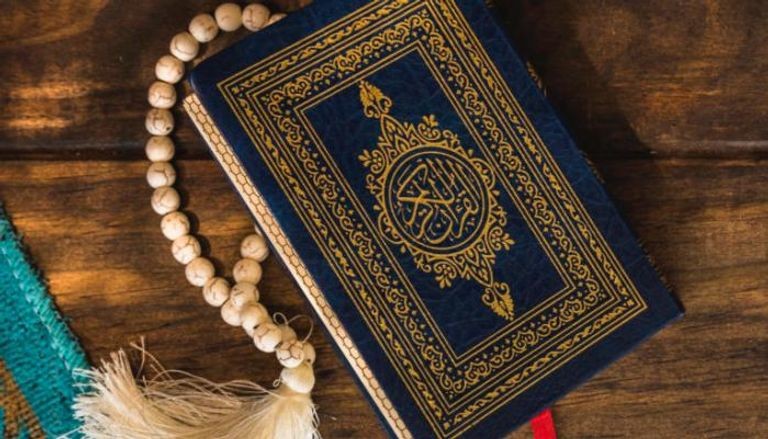
الوصف
موسوعةالأخلاق الإسلامية
المسؤولية عن السلوك الأخلاقي
(هـ) الشرط الخامس:
وهو كون العمل مستطاع الفعل والترك.
فلا مسؤولية عن العمل مع العجز، سواء أكان عجزًا عن الفعل، أو كان عجزًا عن الترك، وبداهة العقول تقضي بأن الاستطاعة شرط لترتب المسؤولية.
أما نصوص الشريعة الدالة على ذلك فمتعددة، منها قول الله تعالى في سورة (البقرة 2):
(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286).
وقوله تعالى في سورة (الأنعام 6):
(لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (152)
وقوله تعالى في سورة (الطلاق 65):
(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا (7) .
فعلى مقدار الهبة الربانية للإنسان تكون درجة التكليف والمسؤولية، وما لا قدرة للإنسان عليه –حتى ولو كان من حركات نفسه- هو خارج عن دائرة مسؤوليته، كالخواطر التي لا يستدعيها بإرادته، وكالهم النفسي بشهوة من الشهوات التي لا يتعمد إثارتها، ولا يتخذ بإرادته أسبابها، وكالحب الذي لا يملك الإنسان جلبه ولا دفعه ولا رفعه، إلى غير ذلك مما هو خارج عن دائرة استطاعة الإنسان، وليس خاضعًا لسلطان إرادته.
لذلك فإننا نستطيع أن نقول في باب الأخلاق: إن المفطور على سرعة الانفعال حتى لا يستطيع أن يملك نفسه ملكًا تامًا، تخف مسؤوليته في مجال خلق الحلم إلى المقدار الذي يملكه من نفسه بإرادته، بخلاف المفطور على بطء الانفعال، فإن مسؤوليته في مجال خلق الحلم تكون أكبر وأعظم، فإذا هو أسرع بالغضب مع قدرته على ضبط نفسه، فإنه يلام بنسبة أكبر من النسبة التي يلام بها المفطور على سرعة الانفعال، نظرًا إلى أنه أقدر على ضبط نفسه منه.
ونظير ذلك المفطور على نسبة عالية من الشح أو الجبن: إن مسؤوليته في مجال الجود أو الإقدام أخف من مسؤولية المفطور على نسبة عالية من الكرم أو الشجاعة وكل منهما تقف مسؤوليته عند حدود استطاعته مغالبة نفسه، فمتى وصل إلى المستوى الذي لا يستطيعه فإن مسؤوليته عندئذ ترتفع، إذ (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) و (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا).
ولكن لا ترتفع المسؤولية في تكليف عام لاحظ فيه الشارع حدود الاستطاعة الموجودة لدى مختلف طبائع الناس، كالزكاة والنفقة الواجبة في باب البذل، وكالخروج إلى الجهاد في سبيل الله عند النفير العام في باب الشجاعة، باستثناء أحوال العذر كالعمى والعرج والمرض بالنسبة إلى الجهاد، وكذلك كل أصحاب الأعذار الذين أعفاهم الشارع أو خفف عنهم من بعض التكاليف.
(و) الشرط السادس:
وهو أن يكون صاحب العمل متمتعًا بحريته عند أداء العمل، غير مكره عليه.
والإكراه: هو الإلزام على سبيل القهر والغلبة بالقيام بعمل من الأعمال المادية الظاهرة، تحت تأثير قوة ملجئة، أو تهديد بانتقام أشد ضررًا وشرًا من الضرر أو الشر اللذين يفضي إليهما العمل المكره عليه، والملزم بالقيام بالعمل كاره له، مقهور عليه، مغلوب على أمره فيه.
ومن المعلوم أن الإرادة لا تكون تامة الحرية في حالة الإكراه، بل هي مغلوبة مستكرهة، لذلك نلاحظ أن الأحكام الإسلامية قررت رفع مسؤولية الإنسان عن الأعمال المادية التي يستكره على فعلها، وذلك ضمن شروط وتفصيلات مبينة في كتب الفقه.
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وهو حديث صحيح لطرقه. ![]()
أي: إن الله تجاوز عن مؤاخذة الإنسان على عمله في كل منها، ضمن شروط الإعفاء من المسؤولية المبينة تفصيلاتها في أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن أول الشروط في رفع المسؤولية عن المكره ألا تتفق إرادته القلبية مع إرادة من استكرهه على العمل، أو ألا تكون إرادته القلبية موافقة على القيام بالعمل لذاته بعيدًا عن ملاحظة حالة الإكراه الضاغطة عليه.
ومن أمثلة ذلك إكراه أولياء الإماء إماءهم على البغاء بسلطان الولاية، قال الله تعالى في سورة (النور 24):
(وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُّهنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33) .
أي: غفور لهن رحيم بهن؛ لأنهن كن مكرهات على ما فعلن كارهات له.
ومن أمثلة ذلك أيضًا أن يكره المؤمن على إعلان الكفر بتهديده وتوعده بالقتل الذي لا يستطيع دفعه، أو بالعذاب الشديد الذي لا يستطيع تحمله. وهنا يوازن المؤمن بين إعلانه الكفر أمام الكافرين وبين قتله وتعذيبه، فقد يرى أن هذا الإعلان أخف شرًا وضرًا من القتل والتعذيب، فينجي نفسه من ذلك بما يرضي عدوه من قول أو فعل، وقلبه مطمئن بالإيمان، أو لا تقوى نفسه على تحمل ما هدد به، فيفعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، قال الله تعالى في سورة (النحل 16):
(مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) .
وذلك لأن الإكراه لا يستطيع أن يصل إلى تحويل القلوب عن إيمانها مهما كان شأنه، إلا أن تتخذ فيه وسائل تسلب معها إرادة الإنسان سلبًا تامًا، وعندئذ ترتفع المسؤولية بسلب الإرادة لا بالإكراه. ويقف مدى تأثير الإكراه عند الإلزام بأعمال مادية ظاهرة فقط، كإعلان الكفر باللسان، فهذا الذي يتجاوز الله عنه في حالة الإكراه. ولا يشمل هذا الحكم فيما نرى من إذا أعلن الكفر ولو على سبيل الإكراه كفر من ورائه ناس مقتدون به كفرًا حقيقيًّا، وذلك لأن الشر الذي ينجم عن إعلانه هذا أشد بكثير من الضر الذي يناله بالموت شهيدًا في سبيل الله، أو بالتعذيب والإيلام.
ومن أجل ذلك لم يأذن الله لحملة رسالاته للناس بمثل هذا الإعلان مهما نالهم من ضرٍ وأذى، فهذا الإذن خاص بالأفراد العاديين الذين لا يتأثر غيرهم بما يظهر منهم.
ورفع المسؤولية عمن يعلن الكفر تحت تأثير الإكراه وقلبه مطمئن الإيمان، يعني رفع المسؤولية الإلزامية، لا رفع المسؤولية مطلقًا، فالمسؤولية الاستحسانية تظل قائمة؛ فالأفضل للمؤمن أن يصبر، ولو أفضى به الأمر إلى التضحية بنفسه في سبيل الثبات على دينه. وقد استطاع كثير من صادقي الإيمان واليقين بالله أن يصبروا، ويتحدوا إكراه المكرهين، ويتحملوا ألوان العذاب التي لم ترفع عنهم حتى لاقوا حتفهم، ولو أنهم تنازلوا فتفوهوا ببعض كلمات الكفر لنجوا، ولكنهم آثروا الصبر والشهادة على التظاهر بالكفر؛ وهذا هو سبيل المحسنين.
ولقد صبر فريق من المستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرًا عظيمًا على ألوان البلاء التي كان المشركون ينزلونها بهم، دون أن يتفوه هؤلاء المستضعفون بما يريد المشركون أن يقولوه من ألفاظ الكفر. وقد أثنى الرسول صلوات الله عليه عليهم وعظم صبرهم، ولم ينههم عما فعلوا. وممن صبروا بلال وخباب وياسر وسمية رضي الله عنهم، وكان ياسر وسمية أول قتيلين استشهدا في الإسلام، بسبب صبرهما وعدم تفوههما بألفاظ الكفر.
وعن خباب بن الأرت –رضي الله عنه- قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال:
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه
رواه البخاري.
وكل إكراه يمكن التخلص منه بوسيلة لا ضرر فيها، أو بوسيلة ضررها أخف من ضرر ما حصل عليه الإكراه، ويستطيع المستكره مباشرتها، فإنه إكراه لا ترتفع معه المسؤولية، ولا يكون مناطًا للاعتذار به في استحقاق العفو.
وليس من الإكراه حمل الإنسان على ارتكاب إثم كبير وجرم خطير عن طريق تهديده بإنزال ضرر فيه دون الضرر الذي يتحقق بذلك الجرم. ومن أمثلة ذلك حمل الجندي على قتل إنسان بريء غير مدان في القضاء الشرعي بالقتل، فإن لم يفعل ما أمر به سرح من عمله، أو سجن، أو حسم من راتبه مبلغ من المال؛ فإنه في مثل هذا غير مكره أصلًا؛ لأنه آثر أن يرتكب جريمة القتل خشية أن يسرح من عمله أو يسجن أو يحسم من راتبه مبلغ من المال، ولن يجد لنفسه عذرًا عند الله بأنه كان مكرهًا على العمل، ولكنه سيلاقي جزاءه، فهو من شركاء الظالمين وأعوانهم.
ومن روائع أمثلة إيثار العذاب على الوقوع في معصية الله ما كان من يوسف عليه السلام، فإنه لما سمع تهديد امرأة العزيز له إذ قالت: (وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّن الصَّاغِرِينَ) ، قال: (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) .
ونأخذ من كلام فقهاء الشريعة أن العمل الذي قد يحصل فيه الإكراه تعتوره الأحكام الخمسة: فقد يكون بالإكراه مباحًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مندوبًا إليه وقد يكون مكروهًا.
فمن أكره بالقتل على شرب الخمر مثلًا وجب عليه أن يشربها حماية لنفسه من القتل؛ لأن ضرر شربها أخف من ضرر التعرض للقتل.
ومن أكره بالقتل على قتل إنسان آخر حرم عليه أن يقتله؛ لأن عملية القتل ستتم على كل حال، ولكنه إذا قتل بسبب الإكراه فقد أضاف إلى جريمة القتل إرادته قتل غيره لينجي نفسه، أما لو لم يفعل فإن جريمة القتل انفردت بها إرادة المكره.
ومن أكره بالقتل على إعلان الكفر جاز له أن يعلن الكفر لينجي نفسه من القتل، ولكن الأفضل له أن يصبر، ما لم ير أن نجاته قد تكون أنفع للإسلام والمسلمين فإن إعلانه الكفر في هذه الحالة هو الأفضل.