موسوعة الأخلاق الإسلامية-الحكم الأخلاقي وأسسه وغاياته (شروط ترتب المسؤولية 3 )
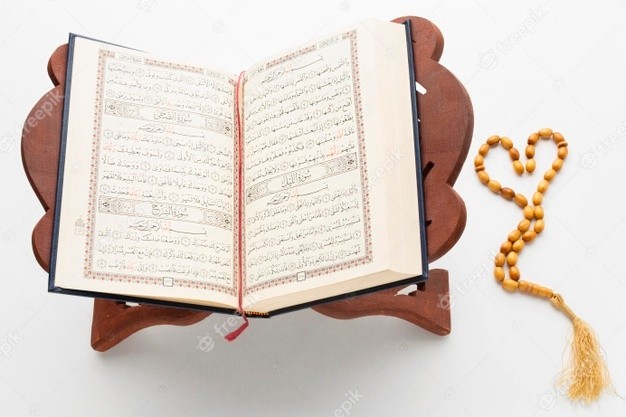
الوصف
الحكم الأخلاقي وأسسه وغاياته
شروط ترتب المسؤولية 3
(د) الشرط الرابع:
وهو العلم بالعمل، وبما يؤدي إليه العمل من خير أو شر، وبحكم العمل الأخلاقي أو الشرعي.
فمن الظاهر في مفاهيم الشريعة أنه لا مسؤولية مع الجهالة التي يعذر بها صاحبها.
وللمعرفة بفضائل الأخلاق ورذائلها طريقان:
الطريق الأول:
ما أودع الخالق في فطر العقول من موازين ذاتية تدرك بها جملة من الفضائل والرذائل، وما أودع في فطر القلوب والنفوس من مشاعر داخلية تحس فيها بطائفة من فضائل الأخلاق ورذائلها.
أما ما يلتقي الناس على إدراكه من ذلك فيعتبر معلومًا بالفطرة، لذلك فإن العدالة الربانية تتولى الجزاء عليه، إن عاجلًا وإن آجلًا، وتعتبر المسؤولية بالنسبة إليه مسؤولية تامة.
فمن أمثلة ذلك الظلم الذي يلتقي جميع الناس على إدراكه كما تدركه أمم من البهائم غير العاقلة؛ ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يفرض على جميع الظالمين يوم القيامة أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، سواء أبلغهم تشريع رباني أو لم يبلغهم ذلك؛ لأن أحدًا لا يجهل قبح الظلم مهما ضعفت مداركه، إلا أن يكون ذا جنون مطبق.
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء –أي: التي لا قرون لها- من الشاة القرناء
وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
الطريق الثاني:
الإعلام المباشر أو بوساطة المبلغين.
1- وقد علم الله أن معظم عبادة سيظلون غافلين عن قضايا الإيمان، وعن كثير من قواعد التشريع والأخلاق، فألزم نفسه بتبليغ عباده شرائعه لهم، عن طريق رسله الذين يصطفيهم للقيام بمهمات التبليغ، وما يتعلق به من وظائف. ولم يتركهم لما أودع في فطرهم من أنوار يستطيعون بها أن يعرفوا الخير والشر والحق والباطل؛ لأن الاستطاعة الفطرية قد تظل راكدة نائمة، فهي بحاجة إلى من يحركها ويوقظها ويبصرها، ويهديها إلى سبيل كمالها.
ولو لم ينزل الله الشرائع لكان للناس أن يحتجوا بجهلهم أو بغفلتهم وعدم انتباههم، ولكان احتجاجهم هذا مقبولًا في محكمة العدل الربانية.
وفي بيان ما ألزم الله به نفسه من إعلام عباده شرائعه لهم؛ يقول تبارك وتعالى في سورة (الإسراء 17):
(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15)
ويقول سبحانه في سورة (التوبة 9):
(وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) .
ويقول في سورة (القصص 28):
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) .
في أمها: أي في نحو عاصمتها التي هي المركز الرئيسي لها، وسائر القرى تابعة لها.
ويقول في سورة (الأنعام 6):
(ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رُّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) .
وفي بيان قطع أعذار الناس حتى لا يعتذروا بالجهل، أو بالغفلة، أو بمواريث البيئة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة (النساء 4):
(رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) .
وفي معرض بيان جذور الإيمان الأولى في فطر الناس، وما جاء من تأكيدها ببلاغات الدين المنزلة، يقول الله تعالى في سورة (الأعراف 7):
(أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) .
2- ولما كان النسيان الذي يعذر به صاحبه حالة من حالات الجهالة؛ لأن الناسي قد ارتفع علمه بالتكليف وقت نسيانه، كان سببًا من أسباب ارتفاع المسؤولية عنه.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
. رواه ابن ماجه والبيهقي، وهو حديث صحيح لطرقه. ![]()
أما النسيان الذي لا يعذر به صاحبه فلا ترفع المؤاخذة بسببه، كالنسيان الناشئ عن الإهمال والتهاون والتقصير، وكنسيان الحقائق الكبرى التي تقترن بالمذكرات الدائمة. انظر بحث النسيان في كتاب "أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها" للمؤلف. ![]()
3- لا يقال باستطاعة الإنسان إذن أن يتهرب من المعرفة، ويبقى في الجهل، ليعفي نفسه من المسؤولية؛ لأن الإنسان مسؤول أولًا عن تعلم ما يجب عليه التزامه من سلوك حسن، ومسؤول عن تعلم ما يجب اجتنابه من سلوك قبيح، ومسؤول ثانيًا عن تطبيق العلم بالعمل.
وقد أنزل الله الشرائع، وأرسل الرسل، فعرفوا الناس، ولفتوا أنظارهم إلى ما يجب عليهم أن يعرفوه ويعملوا به، فلا عذر بعد ذلك للهارب من المعرفة، زاعمًا بذلك أنه يعتصم بالجهل الذي يجعله بريء الذمة، إنه سيسأل مرتين: لم لم يتعلم؟ ولم لم يعمل؟ وقد كان باستطاعته أن يتخلص من الجهل، ويعرف ما يجب عليه أن يعمله، وما يجب عليه أن يجتنبه، وهذا مما هو مسؤول عنه، ومكلف به، وقد لفت نظره إليه.
لكنه إذا سعى وراء المعرفة فلم يصل إليها، أو لم يتسع وقته للوصول إليها، فإن جهله حينئذ غير ناشئ عن تقصير منه، فيعذر به، وترتفع عنه بسببه المسؤولية.
لذلك فلا يعذر عامة المسلمين، إذا تركوا واجباتهم الدينية أو وقعوا في المحرمات الدينية، متعللين بجهلهم بأحكام الشريعة لأنه كان يجب عليهم أن يتعلموا، وقد قصروا بهذا الواجب، فعليهم أن يتحملوا تبعات تقصيرهم.
أما المعذور فعلًا بالجهل، كالذي لم يلفت نظره إلى المعرفة أحد، أو لم يتهيأ له ظروف التعلم مع سعيه إليه، فإن الله يرفع عنه حينئذ المؤاخذة، لعدم مسؤوليته بفقد شرط العلم.