موسوعة الأخلاق الإسلامية-الحكم الأخلاقي وأسسه وغاياته (تربية الضمير الأخلاقي)
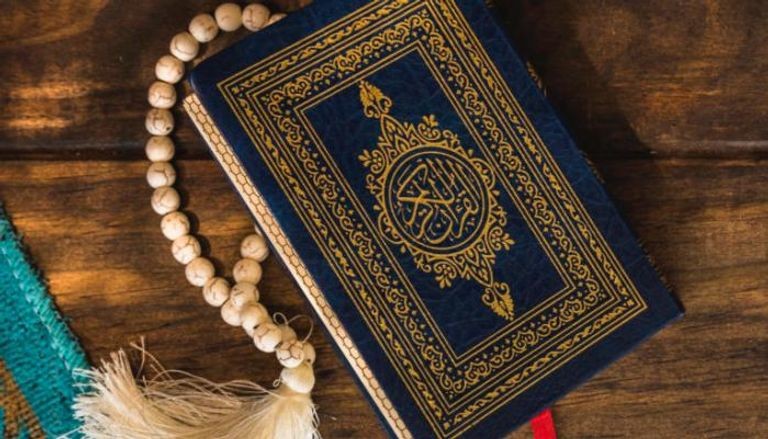
الوصف
الحكم الأخلاقي وأسسه وغاياته
تربية الضمير الأخلاقي
يخضع الضمير الأخلاقي الفطري لأصول التربية وقواعدها، إذ هو قابل للتنمية بممارسة عواطف الخير، وبدراسة كمال فضائل الأخلاق، وما تعطيه من ثمرات فردية واجتماعية –عاجلة وآجلة- وبمواعظ الهداية الدينية والنصائح والوصايا الربانية، وبوسائل الترغيب والترهيب، والقدوة الحسنة، وقصص البطولات الأخلاقية، وغير ذلك من وسائل تربوية.
وخير ضابط له، وأفضل قائد وموجه، التزام طاعة الله، وخير صيانة له صيانته لتقوى الله وخوف عقابه ورجاء ثوابه.
وإهمال تربية الضمير الأخلاقي مما يضعفه، ويجعله يضمر ويتناقص حتى يفقد الحس النبيل، ثم يموت. وقد يفسد ويتحول بوسائل التربية المفسدة، حتى يكون جنديًّا من جنود شيطان الإنسان، ومؤازرًا له في وساوسه ونزغاته.
قواعد لهداية البصيرة الأخلاقية:
إضافة إلى الأسس العامة الموجودة في فطرة النفس الإنسانية فكرًا وإحساسًا داخليًّا ووجدانًا، والتي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:
الحلال بين والحرام بين
توجد قواعد هادية للبصيرة الأخلاقية، نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما يلي:
القاعدة الأولى:
حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره.
القاعدة الثانية:
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.
القاعدة الثالثة:
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
(أ) فالقاعدة الأولى جاءت فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره.
وفي رواية لمسلم:
حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره.
وقد اشتمل هذا البيان النبوي على قاعدة أساسية مرشدة للبصيرة الأخلاقية لدى الإنسان، فإذا عمي أمر السلوك الأخلاقي على هذه البصيرة، هل هو إلى جانب الخير أو إلى جانب الشر، استطاعت هذه القاعدة أن تساعد على معرفة الحقيقة. فإذا كان السلوك من الشهوات التي تلذها الأنفس، كان ذلك مرجحًا لجانب المنع على جانب الإباحة لأن النار حفت بالشهوات.
وإذا كان السلوك من الأمور الثقيلة على الأنفس والمكروهة لها؛ لأنه يخالف هوى من أهوائها أو شهوة من شهواتها، كان ذلك مرجحًا لجانب الخير؛ لأن الجنة حفت بالمكاره.
وقلما يفعل الإنسان الفضيلة حتى يقتحم عقبة من عقبات نفسه، وهذا ما أشار إليه القرآن في وصف الإنسان، بقول الله تعالى في سورة (البلد 90):
(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ (10) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18).
مسغبة: مجاعة. مقربة: قرابة. متربة: فقر ملصق بالتراب.
وعقبات النفس كثيرة، منها عقبة الشح التي تمنع الإنسان عن البذل، واقتحامها يكون بمغالبة النفس، وإلزامها بالبذل في سبيل الله، كالبذل في عتق الرقاب، وإطعام الأيتام والمساكين في الأيام التي تكون الحاجة فيها شديدة إلى الطعام. ومنها عقبة المكاره أو المصائب أو المؤلمات، وعقبة الجهاد في سبيل الله، وعقبة ترك المحرمات، وعقبة القيام بالواجبات، واقتحام هذه العقبات إنما يكون بالصبر وسعة الصدر وقوة الإرادة. ومنها عقبة الأنانية المفرطة، واقتحامها يكون بمغالبة النفس وتغذيتها بمشاعر المرحمة.
وكل ذلك من قبيل المكاره التي تتحملها النفوس على غير هواها، وعلى غير ما تشتهي، وتحملها من مكارم الأخلاق يتحلى بها الإنسان. على أن الحد الفاصل بين الخير والشر قد يكون في بعض الأحوال دقيقًا جدًّا، فإما أن ينحرف الإنسان فيكون من أهل النار، وإما أن يستقيم فيكون من أهل الجنة.
وانزلاق الإنسان إلى مواقع النار قد يكون بخطوة واحدة، وارتقاء الإنسان إلى مراتب الجنة قد يكون بخطوة واحدة. روى البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
(ب) وأما القاعدة الثانية، وهي: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فقد جاء معناها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه
. أول الحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلًا. وأول كلام الرسول فيه:
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم
. انظر رياض الصالحين، رقم الحديث 666. ![]()
وهذه القاعدة تشتمل على ميزان دقيق يهدي البصيرة الأخلاقية إلى فضائل السلوك الأخلاقي، كلما اشتبه على الإنسان أمر السلوك، وفي تطبيق هذه القاعدة ينبغي للإنسان أن يضع نفسه في مكان الآخرين، ويفترض أن الأمر كان معكوسًا، فالأمر الذي يستحسنه لنفسه من الآخرين مما لا معصية لله فيه، هو الأمر الذي تدعو إليه الفضيلة الخلقية، أو يدعو إليه السلوك الأحسن في معاملة الناس.
وعلى المؤمن بناءً على هذا أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وهذا ما جاء بيانه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
.
يشتمل هذا الحديث على قاعدة تصلح لأن تكون من كبريات القواعد الهادية للبصيرة الخلقية، فلدى التأمل يتبين لنا أن معظم الأخلاق الاجتماعية الكريمة تعتمد على هذه القاعدة، وهي أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لاحظ هذه القاعدة والتزم مضمونها في سلوكه الاجتماعي استقام سلوكه، وكان سلوكًا أخلاقيًّا رفيعًا.
إن من يعامل الناس على أساس أن يحب لهم ما يحب لنفسه تمامًا فإنه سيعاملهم حتمًا بكل خلق رفيع؛ لأن هذا هو ما يحب أن يعامله الناس به إذ يحبه لنفسه، وحين يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه يعامله كأنه يعامل نفسًا ثانية له. ومن هنا تنبع معظم فضائل الأخلاق الاجتماعية، ومن هنا يندفع المسلم إلى أن يكون صادقًا مع أخيه؛ لأنه يحب أن يصدقه الناس ويكره أن يكذبوه. ويندفع إلى أن يكون أمينًا على مال أخيه وعرضه وشرفه؛ لأنه يحب أن يعامله الناس بأمانة على ماله وعرضه وشرفه، ويكره أن يخونوه في شيء من ذلك. ويندفع إلى مساعدة أخيه ومعاونته في مال، أو علم، أو جاه، أو خدمة جسدية، أو نصيحة طيبة، أو دعوة صالحة، أو شفاعة حسنة؛ لأنه يحب لنفسه مثل ذلك من إخوانه، ويكره منهم أن يضنوا عليه بمعونة أو مساعدة في شيء من ذلك. ويندفع إلى دعوة أخيه إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح؛ لأنه قد أحب لنفسه هذا فهو يحب لأخيه ما أحب لنفسه.
ومن هنا يجد المسلم نفسه مدفوعًا إلى الصبر على أخيه المسلم كلما دعت ظروف التعامل إلى الصبر؛ لأنه يحب من الناس أن يصبروا عليه، كلما بدر منه ما لا يقبله الناس منه إلا بصبر. ويجد المسلم نفسه مدفوعًا إلى العفو والصفح والمسامحة والإغضاء عن الهفوات والسيئات، كلما وجد من إخوانه ما يسوؤه من تصرفاتهم معه؛ لأنه يحب من الناس أن يعاملوه بالصفح والعفو والمسامحة والإغضاء عن الهفوات والسيئات، كلما بدر منه من تصرفات تسوء إخوانه. ويجد نفسه مدفوعًا إلى ستر عيوب إخوانه وعدم نشرها بين الناس وعدم فضيحتهم بها، فهو إذن يكف عن غيبتهم، والحديث عنهم بما يكرهون، ويحاول جاهدًا ستر عيوبهم، ويحرص على أن ينصحهم سرًا ما وجد إلى ذلك سبيلًا، لا أن ينصحهم علنًا بين الناس، كاشفًا عيوبهم؛ لأن ذلك فضيحة لا نصيحة، وهو يعاملهم بهذا لأنه يحب لنفسه من إخوانه مثل ذلك. ويكره منهم أن ينشروا معايبه، ويغتابوه بما يكره، وهو يكره أيضًا منهم أن يوجهوا له نصائح علنية بترك بعض العيوب التي فيه؛ لأنه يرى ذلك فضيحة له، وهو يكره الفضيحة.
وهكذا نلاحظ بالتتبع تدفق كثير من الفضائل الخلقية الاجتماعية من منبع هذه القاعدة الخلقية: أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه.
ففي هذا الحديث تأصيل لقاعدة عظيمة من قواعد التربية الخلقية، والهادية للبصيرة الأخلاقية إلى كثير من فضائل الأخلاق.
وربط الحديث هذه القاعدة بالإيمان؛ لأن الإيمان هو المنبع الأساسي الأمثل لكل فضيلة في السلوك، سواء أكان سلوكًا يدخل في باب الأخلاق، أو في باب الآداب، أو في أي باب آخر من أبواب السلوك، وسواء أكان سلوكًا فرديًّا أو سلوكًا اجتماعيًّا.
الإيمان الصحيح الكامل طاقة عظيمة مقومة لسلوك الإنسان، ومن أجل ذلك اهتم الإسلام في الدرجة الأولى بغرس الإيمان في قلوب المسلمين، وجعله الأساس الأول الذي تبنى عليه كل التعاليم الإسلامية، وربط به كل الفضائل.
وفي ربط كل سلوك المسلم بالقاعدة الإيمانية توحيد للمنطلق النفسي وللمنطلق الفكري في كيان الإنسان، وفي هذا بعد عن التعقيد، ولجوء إلى البساطة الفطرية، التي تناسب واقع حال الإنسان، ومع هذه البساطة الفطرية التي لا تعقيد فيها تتجلى الحقيقة بكل إشراقها ونقائها، وبكل نورها وصفائها.
وماذا يطلب الباحث الحصيف غير الحقيقة البسيطة المنسجمة مع أفضل ما يصلح الإنسان كل الإنسان فكرًا ونفسًا وقلبًا وسلوكًا؟
وهذا ما يسعى للوصول إليه كل المخلصين من العلماء والباحثين الإنسانيين، من الفلاسفة، وعلماء الأخلاق، وعلماء الاجتماع، ولكن يصل إليه من يهتدي بهدي الإسلام، أو يسترشد بنور الفكر المشرق بنور الله، ويضل عنه من يخوض في متاهات الأهواء، ويتبع خطوات الشياطين، وينخدع بفلسفات المضلين.
الإيمان هو أعظم جوهرة في الوجود تنزلت من السماء، فتلقفتها قلوب المؤمنين، فاحتفظت بها كنزًا ثمينًا، فأشرقت في حياتهم عملًا صالحًا، وخلقًا كريمًا.
والإيمان أعظم عنصر مسعد في حياة الإ