موسوعة الأخلاق الإسلامية-مقدمات وأسس عامة ( الحس الأخلاقي أو الضمير الأخلاقي )
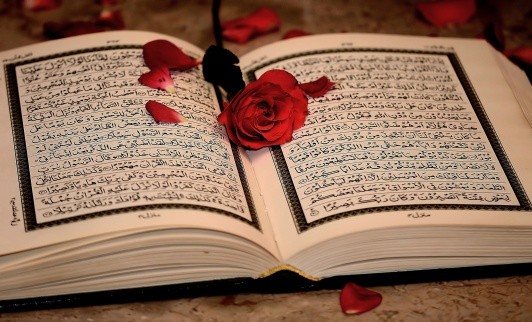
الوصف
مقدمات وأسس عامة
الحس الأخلاقي أو الضمير الأخلاقي
لقد أودع الخالق العظيم في مدارك الأفكار وفي مشاعر الوجدان الفطرية ما تدرك به فضائل الأخلاق ورذائلها، ونستطيع أن نسمي ذلك "الحس الأخلاقي".
وهذا ما يجعل الناس يشعرون بقبح العمل القبيح وينفرون منه، ويشعرون بحسن العمل الحسن ويرتاحون إليه، وبذلك يمدحون فاعل الخير، ويذمون فاعل الشر.
وقد أرشدت النصوص الإسلامية إلى وجود هذا الحس الأخلاقي في الضمائر الإنسانية، وأحالت المسلم المؤمن إلى استفتاء قلبه في حكم السلوك الذي قد تميل نفسه إلى ممارسته.
ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى في سورة (الشمس 91):
(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10) .
زكاها:
نماها وارتقى بها. وعكس ذلك
دساها:
أي دفنها وهبط بها.
فالنفس الإنسانية منذ تكوينها وتسويتها ألهمت في فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها، وهذا هو الحس الفطري الذي تدرك به الخير والشر، ولذلك كان على الإنسان أن يزكي نفسه ويطهرها من الإثم حتى يظفر بالفلاح وإلا خاب سعيه.
ويقول الله تعالى في سورة (القيامة 75):
(بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) .
فالإنسان لديه بصيرة يستطيع أن يحاسب بها نفسه محاسبة أخلاقية، على أعماله ومقاصده منها، ولو حاول في الجدل اللساني الدفاع عن نفسه وإلقاء معاذيره.
ويقول الله تعالى في سورة (البلد 90):
(لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ (10) .
لبدًا: أي كثيرًا مجتمعًا بعضه على بعض.
فالإنسان كما لديه أدوات الحس الظاهر، لديه حس باطن يدرك به طريقي الخير والشر، وهما النجدان الممتدان في أرض حياته الدنيا، يختار منهما لسلوكه ما يشاء، وعليه بعد ذلك أن يتحمل نتائج عمله، ونتائج اختياره.
وهذا الحس الباطن يشمل ما تدركه الأفكار السليمة بموازينها التي فطرها الله عليها، ويشمل ما تحس به الضمائر بمشاعرها الوجدانية التي فطرها الله عليها، ومن ذلك يتكون في الإنسان حسه الأخلاقي.
وروى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
.
فهذا الحديث يدل على أن في النفس الإنسانية حسًا خلقيًّا بالإثم، ولذلك يكره فاعل الإثم أن يطلع عليه الناس؛ لأنه يعلم أنهم يشعرون بمثل ما يشعر، وذلك بحس أخلاقي موجود في أعماق نفوسهم، وهذا الحس الأخلاقي هو ما اكتشفه الباحثون الأخلاقيون من الفلاسفة، وأسموه (الضمير).
وروى الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
جئت تسأل عن البر؟
قلت: نعم. فقال:
استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك
.
ففي هذا الحديث تبيان واضح للحس الأخلاقي، ولا مانع من أن نسميه الضمير الأخلاقي، وهذا الضمير إذا كان نقيًّا سليمًا من العلل والأمراض، فإنه يستطيع أن يحس بفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك، وأن يحس برذائل الأخلاق ومساوئ السلوك، وأن يميز بين الصنفين، وقد جمع الرسول صلوات الله عليه فضائل الأخلاق تحت عنوان (البر) وجمع رذائل الأخلاق تحت عنوان (الإثم).
وفي هذا الحديث أيضًا إشارة إلى مواقع الحس الأخلاقي داخل النفس الإنسانية وهو ما قد يطلق عليه اسم الضمير، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث:
البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب
. وهذا يدل على أن في النفس الإنسانية قدرة على الإحساس بالبر، أو حاسة خاصة تحس به، ومثل ذلك يوجد في القلب أيضًا، بل القلب أحرى بمثل هذه الحاسة وأجدر بها، فالضمير أو الحس الأخلاقي موجود في النفس وموجود في القلب، أو آثاره تظهر فيهما.
وقد نتساءل: هل يوجد انفصال بين النفس والقلب؟
ونجيب بأنه قد يكون الجهاز العام واحدًا غير أن منافذ الإحساس متعددة، ولكل منها خصائصه: فالنفس يغلب عليها أنها مجمع الغرائز والأهواء والشهوات والمخاوف والمطامع، والقلب مجمع التفكير والعواطف الثابتة. وفي الباب الثاني من هذا الكتاب تفصيل المفاهيم الإسلامية المتعلقة بالنفس والقلب والصدر وغيرها.
وعلى الرغم من أن النفس هي مجمع الغرائز والأهواء والشهوات والمخاوف والمطامع، فإنها تستحسن محاسن الأخلاق، وتستقبح مساويها، وهي بطبيعتها تميل إلى أن تعامل من قبل الآخرين بالخلق الحسن، وتنفر من أن تعامل بالخلق القبيح، فلديها إحساس بهما، إذا كانت نفسًا سليمة من العلل، بريئة من الأمراض، سواء أكانت هذه أصيلة فيها أو طارئة عليها، وأما القلب الذي هو مركز التفكير مع العواطف أو مجمعهما أو آثارهما تتجمع فيه، فمن الطبيعي فيه أن يكون لديه هذا الإحساس؛ لأن عمدته الفكر السليم والفطرة الصافية، وحين نرجع إلى ضمائرنا نشعر بذلك.
فالبر المفسر في كلام الرسول بأنه حسن الخلق يفعله الإنسان السوي وهو مطمئن القلب، ومطمئن النفس، أما الإثم فإن الإنسان السوي لا يقدم عليه إلا وفي نفسه قلق منه، وفي صدره تردد واضطراب.
والطمأنينة في النفس والقلب علامة على أن العمل هو من أعمال البر، والتردد والاضطراب فيهما وخوف اطلاع الناس على العمل أو على الغرض منه علامة على أنه من أعمال الإثم.
ولكن قد يختلط الأمر في بعض الأعمال على العقل والضمير، ويلتبس عليهما وجه الحق، فيكونان حينئذٍ بحاجة إلى هداية وتبصير، وقد تطغى عليهما الأهواء والشهوات أو العادات والتقاليد، أو يؤثر عليهما القادة المضلون، أو الشياطين الموسوسون من الجن والإنس. وفي هاتين الحالتين تقف الشريعة الربانية فيها هداية وتبصير، فتدل بنصوصها أو بأماراتها على نوع الحكم الأخلاقي وعلى درجته.
وسبب اختلاط الأمر والتباسه على الحس الأخلاقي في الإنسان، قد يكون راجعًا إلى اشتباه القضية الأخلاقية، وغموض مدرك الحكم فيها، وعدم ظهور وجه الحق والخير.
وطريقة المسلم في هذه الحالة هي اتقاء الشبهات، فإذا كان اتقاء الشبهات في جانب الترك –لأن الأمر مشتبه بين الحلال والحرام- كان الأفضل والخير للمسلم أن يترك العمل المشتبه فيه، خشية الوقوع في الحرام، وإذا كان اتقاء الشبهات في جانب الفعل -لأن الأمر مشتبه بين الحلال والواجب- كان الأفضل والخير للمسلم أن يأتي بالعمل المشتبه فيه، خشية الوقوع في ترك الواجب، أي خشية الوقوع في الحرام؛ لأن ترك الواجب حرام.
والدليل على هذه الطريقة التي ينبغي للمسلم أن يتبعها، ما رواه البخاري ومسلم من عدة طرق، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
.
فهذا الحديث يحدد ويصور بمنتهى الروعة والدقة واقع حال إدراك الناس للخير والشر، والحق والباطل، فمن ذلك ما هو واضح لا غموض فيه، ومنه ما هو مشتبه يخفى واقع حاله على كثير من الناس، وهنا يقع الخلاف، ويقع الالتباس، والأفضل للمسلم دائمًا اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه عند الله، واستبرأ لعرضه عند الناس، وسيأتي شرح موسع لهذا الحديث إن شاء الله.
ويدل عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دع ما يريبك إلا ما لا يريبك،
فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة
قال الترمذي: حديث صحيح.
أي دع ما يحدث في قلبك الاضطراب والقلق والشك بسوء العاقبة والوقوع في الشر والإثم، إلى ما لا يحدث في قلبك شيئًا من ذلك، بل يحدث في قلبك الطمأنينة والراحة والأمن.
ثم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحدث الطمأنينة بالصدق، ومثل لما يحدث الريبة بالكذب، فالكاذب مرتاب قلق، والصادق مطمئن النفس آمن.
وفي هذا إشارة إلى أن التزام الفضيلة الخلقية مما يورث في النفس سعادة الطمأنينة، بخلاف القلق الذي ينشأ عن الريبة فهو عذاب للنفس، وألم ممض مقض للمضاجع.
وظاهر في هذا الحديث التنبيه على الحس الأخلاقي الموجود في ضمير الإنسان، وهذا الحس الأخلاقي يتمثل في بعض أحواله بالشك والتردد، وحينما يوجد هذا الريب المقلق للنفس فالحكمة تقضي بالبعد عما يحدث الريب، والأخذ في الطريق الذي لا ريب فيه، ما دام يوجد أمام الإنسان طريق فيه طمأنينة وراحة للنفس وأمن.
ولما كان الإنسان مزودًا في فطرته بحس أخلاقي كافٍ لإدراك الخير والشر والحق والباطل، كان قادرًا على أن يحاسب نفسه على عمله حسابًا دقيقًا، ولذلك يقال له يوم القيامة عند تسليمه كتاب عمله الذي عمله في الحياة الدنيا:
(اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) .
فيحال على محكمة الضمير ليعرف بنفسه ما له وما عليه؛ قال الله تعالى في سورة (الإسراء: 17):
(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14).
طائره: أي عمله الذي يصدر عنه وينطلق فلا يستطاع إرجاعه.
ثم تجري محاسبته بعد ذلك ليرى أن محكمة العدل الربانية محكمة لا تظلم أحدً