كتاب المفردات في غريب القرآن - كتاب الخاء (خلط - خلع - خلف)
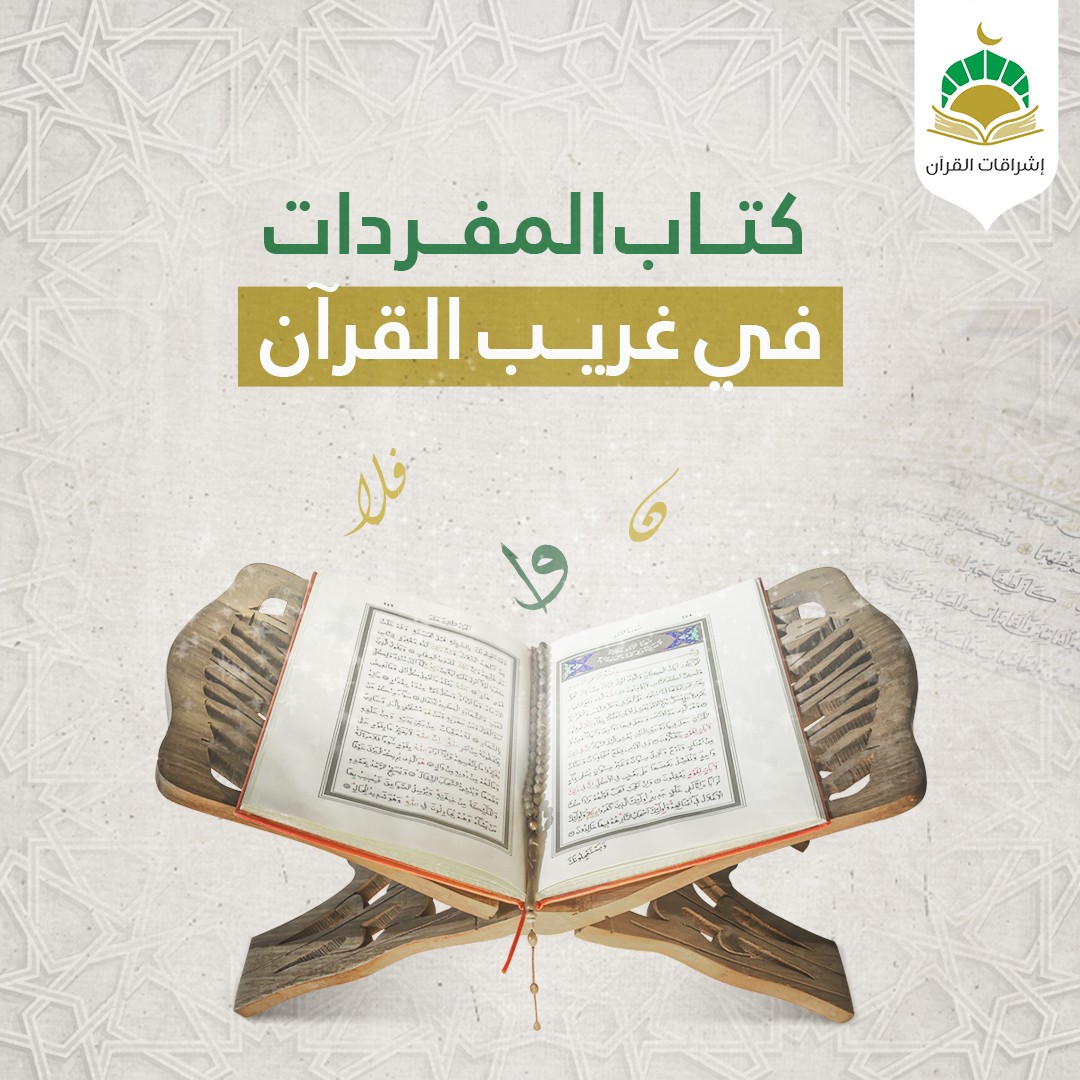
الوصف
كتاب الخاء
(خلط - خلع - خلف)
[خلط]
الخَلْطُ: هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعدا، سواء كانا مائعين، أو جامدين، أو أحدهما مائعا والآخر جامدا، وهو أعمّ من المزج، ويقال اختلط الشيء،
قال تعالى: (فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ) [يونس/ ٢٤] ، ويقال للصّديق والمجاور والشّريك: خَلِيطٌ، والخليطان في الفقه من ذلك،
قال تعالى: (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) [ص/ ٢٤] ، ويقال الخليط للواحد والجمع، قال الشاعر: بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا
وقال: (خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) [التوبة/ ١٠٢] ، أي: يتعاطون هذا مرّة وذاك مرّة، ويقال: أخلط فلان في كلامه: إذا صار ذا تخليط، وأخلط الفرس في جريه كذلك، وهو كناية عن تقصيره فيه.
[خلع]
الخَلْعُ: خلع الإنسان ثوبه، والفرس جلّه وعذاره، قال تعالى: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) [طه/ ١٢] ، قيل: هو على الظاهر، وأمره بخلع ذلك عن رجله، لكونه من جلد حمار ميّت ، وقال بعض الصوفية: هذا مثل وهو أمر بالإقامة والتمكّن، كقولك لمن رمت أن يتمكّن: انزع ثوبك وخفّك ونحو ذلك، وإذا قيل: خَلَعَ فلان على فلان، فمعناه: أعطاه ثوبا، واستفيد معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به على فلان، لا بمجرّد الخلع.
[خلف]
خَلْفُ: ضدّ القُدَّام، قال تعالى: (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) [البقرة/ ٢٥٥] ، وقال تعالى: (لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) [الرعد/ ١١] ، وقال تعالى: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) [يونس/ ٩٢] ، وخَلَفَ ضدّ تقدّم وسلف، والمتأخّر لقصور منزلته يقال له: خَلْفٌ، ولهذا قيل: الخلف الرديء، والمتأخّر لا لقصور منزلته يقال له: خلف، قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) [الأعراف/ ١٦٩] ، وقيل: سكت ألفا ونطق خلفا . أي: رديئا من الكلام، وقيل للاست إذا ظهر منه حبقة : خُلْفَة، ولمن فسد كلامه أو كان فاسدا في نفسه، يقال: تَخَلَّفَ فلان فلانا: إذا تأخّر عنه وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه، ومصدره الخِلَافةَ بالكسر، وخَلَفَ خَلَافَةً بفتح الخاء: فسد ، فهو خالف، أي: رديء أحمق، ويعبّر عن الرديء بخلف نحو: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ) [مريم/ ٥٩] ، ويقال لمن خلف آخر فسدّ مسدّه: خَلَف، والخِلْفَةُ يقال في أن يخلف كلّ واحد الآخر، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) [الفرقان/ ٦٢] ، وقيل: أمرهم خلفة، أي: يأتي بعضه خلف بعض،
قال الشاعر: بها العين والآرام يمشين خلفة وأصابته خلفة: كناية عن البطنة، وكثرة المشي، وخَلَفَ فلانٌ فلانا، قام بالأمر عنه، إمّا معه وإمّا بعده،
قال تعالى: (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) [الزخرف/ ٦٠] ، والخِلافةُ النّيابة عن الغير إمّا لغيبة المنوب عنه، وإمّا لموته، وإمّا لعجزه، وإمّا لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) [فاطر/ ٣٩] ، (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ) [الأنعام/ ١٦٥] ، وقال: (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ) [هود/ ٥٧] ، والخلائف: جمع خليفة، وخلفاء جمع خليف، قال تعالى: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص/ ٢٦] ، (وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ) [يونس/ ٧٣] ، (جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) [الأعراف/ ٦٩] ، والاختلافُ والمخالفة: أن يأخذ كلّ واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخِلَاف أعمّ من الضّدّ، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلّ مختلفين ضدّين، ولمّا كان الاختلاف بين النّاس في القول قد يقتضي التّنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة،
قال: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ) [مريم/ ٣٧] ، (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود/ ١١٨] ، (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ) [الروم/ ٢٢] ، (عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) [النبأ/ ١- ٢- ٣] ،
(إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) [الذاريات/ ٨] ، وقال: خلفا . أي: رديئا من الكلام، وقيل للاست إذا ظهر منه حبقة : خُلْفَة، ولمن فسد كلامه أو كان فاسدا في نفسه، يقال: تَخَلَّفَ فلان فلانا: إذا تأخّر عنه وإذا جاء خلف آخر، وإذا قام مقامه، ومصدره الخِلَافةَ بالكسر، وخَلَفَ خَلَافَةً بفتح الخاء: فسد ، فهو خالف، أي: رديء أحمق، ويعبّر عن الرديء بخلف نحو: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ) [مريم/ ٥٩] ، ويقال لمن خلف آخر فسدّ مسدّه: خَلَف، والخِلْفَةُ يقال في أن يخلف كلّ واحد الآخر، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) [الفرقان/ ٦٢] ، وقيل: أمرهم خلفة، أي: يأتي بعضه خلف بعض، قال الشاعر: بها العين والآرام يمشين خلفة وأصابته خلفة: كناية عن البطنة، وكثرة المشي، وخَلَفَ فلانٌ فلانا، قام بالأمر عنه، إمّا معه وإمّا بعده، قال تعالى: (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) [الزخرف/ ٦٠] ، والخِلافةُ النّيابة عن الغير إمّا لغيبة المنوب عنه، وإمّا لموته، وإمّا لعجزه، وإمّا لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) [فاطر/ ٣٩] ،
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ) [الأنعام/ ١٦٥] ، وقال: (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ) [هود/ ٥٧] ، والخلائف: جمع خليفة، وخلفاء جمع خليف،
قال تعالى: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص/ ٢٦] ، (وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ) [يونس/ ٧٣] ، (جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) [الأعراف/ ٦٩] ، والاختلافُ والمخالفة: أن يأخذ كلّ واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخِلَاف أعمّ من الضّدّ، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلّ مختلفين ضدّين، ولمّا كان الاختلاف بين النّاس في القول قد يقتضي التّنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة،
قال: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ) [مريم/ ٣٧] ، (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود/ ١١٨] ، (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ) [الروم/ ٢٢] ، (عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) [النبأ/ ١- ٢- ٣] ،
(إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) [الذاريات/ ٨] ، وقال: (مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) [النحل/ ١٣] ، وقال: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) [آل عمران/ ١٠٥] ،
وقال: (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ) [البقرة/ ٢١٣] ، (وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) [يونس/ ١٩] ،
(وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [يونس/ ٩٣] ، وقال في القيامة: (وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [النحل/ ٩٢] ، وقال: (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ) [النحل/ ٣٩] ، وقوله تعالى: (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ) [البقرة/ ١٧٦] ، قيل معناه: خلفوا، نحو كسب واكتسب،
وقيل: (أتوا فيه بشيء خلاف ما أنزل الله، وقوله تعالى: لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ) [الأنفال/ ٤٢] ، فمن الخلاف، أو من الخلف، وقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) [الشورى/ ١٠] ،
وقوله تعالى: (فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [آل عمران/ ٥٥] ، وقوله تعالى: (إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [يونس/ ٦] ، أي: في مجيء كلّ واحد منهما خلف الآخر وتعاقبهما، والخُلْفُ: المخالفة في الوعد.
يقال: وعدني فأخلفني، أي: (خالف في الميعاد بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ) [التوبة/ ٧٧] ، وقال: (إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) [الرعد/ ٣١] ، وقال: (فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) [طه/ ٨٦] ،
(قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا) [طه/ ٨٧] ، وأخلفت فلانا: وجدته مُخْلِفاً، والإخلاف: أن يسقي واحد بعد آخر، وأَخْلَفَ الشجرُ: إذا اخضرّ بعد سقوط ورقه، وأَخْلَفَ الله عليك، يقال لمن ذهب ماله، أي: أعطاك خلفا، وخَلَفَ اللهُ عليك، أي: كان لك منه خليفة، وقوله: لا يلبثون خلفك : بعدك، وقرئ: خِلافَكَ أي: مخالفة لك،
وقوله: (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) [المائدة/ ٣٣] ، أي: إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر. وخَلَّفْتُهُ: تركته خلفي، قال (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) [التوبة/ ٨١] ، أي: مخالفين، وَعَلَى (الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) [التوبة/ ١١٨] ، (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ) [الفتح/ ١٦] ، والخالِفُ: المتأخّر لنقصان أو قصور كالمتخلف، قال: (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ) [التوبة/ ٨٣] ، والخَالِفةُ: عمود الخيمة المتأخّر، ويكنّى بها عن المرأة لتخلّفها عن المرتحلين، وجمعها خَوَالِف، قال: (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) [التوبة/ ٨٧] ، ووجدت الحيّ خَلُوفاً، أي: تخلّفت نساؤهم عن رجالهم، والخلف: حدّ الفأس الذي يكون إلى جهة الخلف، وما تخلّف من الأضلاع إلى ما يلي البطن، والخِلَافُ: شجر كأنّه سمّي بذلك لأنّه فيما يظنّ به، أو لأنّه يخلف مخبره منظره، ويقال للجمل بعد بزوله: مخلف عام، ومخلف عامين. وقال عمر رضي الله عنه: (لولا الخِلِّيفَى لأذّنت) أي: الخلافة، وهو مصدر خلف.